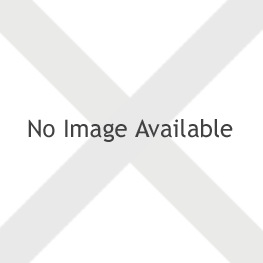هل تكون اللحظة التونسية فارقة في الزمان العربي ؟
في مقال هام للكاتب جمال خاشقجي في الحياة اللندنية يقول فيه، بان الحركة الإسلامية عمرها يقترب من القرن، وهي جزء من عالم إسلامي تغيّر ولا يزال يتغيّر بحكم الحداثة ومفهوم الدولة الحديثة ذات الحدود والسيادة والمواطنة، بالتالي لا بد من أن تتغيّر مثلما تغيّر المواطن وونغيرت الاوطان.
وهنا يمكن القول والحق يقال بأن الحركة أكثر تقدمية من الأنظمة ! وتغيّرت أكثر بكثير مما تغيّرت الأنظمة، فمظاهر الحداثة التي اتسمت بها الجمهوريات العربية، كالدستور والبرلمان وعلمانية وتحديث المجتمع، مجرد «منظرة» لنظام مملوكي وحكم عضوض عمره اكثر من ألف سنة، يقوم في جوهره على مبدأ الاستئثار بالسلطة والمال، فلم يكن حسني مبارك أو صدام حسين او غيرهما يختلفان كثيراً عن أي سلطان مملوكي منشغل بالحكم وتثبيته، ومن ثم توريثه لابن أو شقيق او صهر وحسيب.
ولقد زعم العسكر في بلداننا أن لديهم مشروعاً للنهضة، والتحرير، والعدالة، والتصنيع والتعليم، والتنمية بكل اشكالها، ولكن ما لبث أن انهار لافتقاده المقومات الأخلاقية، بعدما اختاروا عدم إصلاح النظام السياسي الديموقراطي الذي ثاروا من أجل إصلاحه، واستبدلوه بنظام خاوٍ أساسه الاستخبارات والبطش، فجمدوا أو شوّهوا عملية التحول الديموقراطي لأكثر من نصف قرن.
اما مشروع الإسلام السياسي، فقد بدأ بحلم يحبو ويدور حول إعادة الخلافة، إذ اعتقدوا أن فيها السر لعودة عز المسلمين والعرب ووحدتهم، ولكن كلما امتد نشاطهم في العمل العام انتبهوا إلى استحالة ذلك، نتيجة حالة الانهيار التي تعيشها أوطانهم، من فقر وضعف، وهيمنة أجنبي، وفساد، وأصبحوا واقعيين أكثر، ولكن كانت واقعية متدرجة وعبر مراحل، بحثوا عن فرص إقامة نموذج إسلامي إقليمي يحيون فيه حكم الشريعة المهددة، ويطبّقون عليه أفكارهم في التربية والتعليم، وقد استعانوا بالمرأجع بعد أن ألّفوا المزيد من الكتب التي توفق بين الديموقراطية والإسلام. ولقد تسأل بعضهم،
هل ندمقرط الإسلام أم نؤسلم الديموقراطية؟
وبعدها اكتشفوا لاحقاً أن لا هذا ولا ذاك ممكن، بمزيد من الواقعية.
فالراحل محفوظ النحناح في الجزائر طرح نظرية «الشوراديموقراطية»، لم تعش الفكرة أبعد من تصريح أو اثنين قالهما، فدخلت السلفية على الخط، وأعادت الجميع إلى مربع الأسئلة الأولى، هل يجوز التصويت على الشريعة وهي أمر إلهي فتكون عرضة لاختيار أو رفض البشر؟ بدت حكومات العسكر مستعصية على التغيير، وأنها واقع لا مفرّ منه، يعيشون في ظلها، فخفضوا من سقف مطالبهم ! ومن ثم اقتنع جيل من الحركات الاسلامية بانه يكفي إدخال الشريعة في الدساتير، وانشغل الإخوان المسلمون في مصر بهذا الشأن مع الرئيس السادات فاستجاب لهم، فكان الجدل حول هل تكون المصدر الأساس للتشريع أم مصدراً للتشريع، ثم انتبهوا أن لا فرق بين هذا أو ذاك، فالحكم أقوى من الدستور، والرئيس وحزبه وحكومته والمقربون هم أصحاب القرار الأخير، في الحرب والسلم، والسياسة والاقتصاد، والتعليم، والمصالح والمزايا والعلاقات الخارجية، وكل شيء.
سنوات تمرّ، يتغير فيها المجتمع والأوطان تدخل الحروب لتنتهي بهزائم، والأمة تزداد ضعفاً وهشاشة بينما العالم يتطور، ويعلي من شأن الإنتاج الاخترعات والامم تقوى، وهم يرون أن الديموقراطية هي سمة الدول الناجحة حتى خارج دول أوروبا التي صنعتها، وطبقتها كوريا الجنوبية واليابان والهند، وكثير من دول الشرق والغرب، ولم يعد من المقنع القول إن الديموقراطية فكرة غربية، وهو ذلك الغرب الذي احتربنا معه لقرون لنرفض أفكاره، ومن ثم حالفناه وقبلنا التحالف معه والحماية به ضد بعضنا البعض حتى ايامنا !
فمن خلال ذلك الزمن الطويل، المملوء بالإخفاقات على مستوى الوطن، وكذلك الحركة، وألم المعتقلات، وعجز الجميع عن تحقيق التغيير الذي بدأ قبل مئة عام، كانت هناك تجربة «إسلامية» تتشكل في تركيا، بدأت من قاعدة «أعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة» إلى الدخول المتدرج فيها، وإخفاق يتلو إخفاقاً مع إصرار وتكيف إلى قاعدة «يمكن الدولة أن تكون علمانية، ولكن قادتها غير علمانيين»، والتي صاغها رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان لإخوان مصر، حين زارهم وهم في الحكم، ولم يأخذوا بها.
تلك الدولة العلمانية والتي يحكمها غير علماني نجحت في تركيا، وتجاوزت الإشكال الشرعي المتوارث، وأصبحت نموذجاً للإسلاميين، فأضيف نجاحها إلى تلك المتغيرات التي عاشتها الأوطان والمجتمعات المسلمة طوال القرن، فكان لا بد أن تتغير الحركة الإسلامية إذا أرادت الاستمرار، فعلت ذلك بهدوء في المغرب، وبصخب في تونس، وعجز عن ذلك آخرون مثل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، إما لعجز فيهم، وإما لأن البيئة المحيطة بهم لم تتغيّر بما فيه الكفاية.
ولكن شروط التغيّر تتطلب أن يكون في بيئة ديموقراطية موثوقة وهو ما تفتقر اليه اغلب التجارب السابقة،
بالتأكيد للزعامات دورها، فالغنوشي مفكر إسلامي متقدم فكرياً على نظرائه الاسلاميين منذ زمن، وبالتالي لا بد من الاعتراف بدوره، كما أردوغان تركيا وبن كيران المغرب الذين لهما كاريزما الزعامة الجماهيرية، وفي طبعهما الإقدام، فنجحا في قيادة حزبيهما لهذه القفزة الكبيرة.
وعلى الاخوان المسلمون في مصر ان يعترفوا بضياع الفرصة بعد ان انشغلوا بقضية الهوية، والاستئثار بالحكم، بينما كان عليهم بناؤها وتعميق جذورها أولاً قبل الإدارة والتمكين وخطط التنمية ومشروع النهضة والإصلاح الاقتصادي والتعليمي وأي شيء آخر، فالإجابة عن معضلة تداول السلطة هي نصف الطريق لنهضة الجميع وليس جماعتهم وحدها، وهو ما فعله الغنوشي، استقرت الديموقراطية في بلاده، وبات هو وحزبه «الديموقراطي الإسلامي» مستعدَين للقفز على السلطة في الانتخابات المقبلة.
وأخيراً يقول الكاتب الخاشقجي، لو حضرت المؤتمر لسألته “والمقصود هو الشيخ راشد الغنوشي”
هل نستمر بإطلاق لقب”الشيخ”على الدعوي السابق والنهضوي والسياسي اللاحق الاستاذ راشد الغنوشي “أم السيد الرئيس”؟
في مقال هام للكاتب جمال خاشقجي في الحياة اللندنية يقول فيه، بان الحركة الإسلامية عمرها يقترب من القرن، وهي جزء من عالم إسلامي تغيّر ولا يزال يتغيّر بحكم الحداثة ومفهوم الدولة الحديثة ذات الحدود والسيادة والمواطنة، بالتالي لا بد من أن تتغيّر مثلما تغيّر المواطن وونغيرت الاوطان.
وهنا يمكن القول والحق يقال بأن الحركة أكثر تقدمية من الأنظمة ! وتغيّرت أكثر بكثير مما تغيّرت الأنظمة، فمظاهر الحداثة التي اتسمت بها الجمهوريات العربية، كالدستور والبرلمان وعلمانية وتحديث المجتمع، مجرد «منظرة» لنظام مملوكي وحكم عضوض عمره اكثر من ألف سنة، يقوم في جوهره على مبدأ الاستئثار بالسلطة والمال، فلم يكن حسني مبارك أو صدام حسين او غيرهما يختلفان كثيراً عن أي سلطان مملوكي منشغل بالحكم وتثبيته، ومن ثم توريثه لابن أو شقيق او صهر وحسيب.
ولقد زعم العسكر في بلداننا أن لديهم مشروعاً للنهضة، والتحرير، والعدالة، والتصنيع والتعليم، والتنمية بكل اشكالها، ولكن ما لبث أن انهار لافتقاده المقومات الأخلاقية، بعدما اختاروا عدم إصلاح النظام السياسي الديموقراطي الذي ثاروا من أجل إصلاحه، واستبدلوه بنظام خاوٍ أساسه الاستخبارات والبطش، فجمدوا أو شوّهوا عملية التحول الديموقراطي لأكثر من نصف قرن.
اما مشروع الإسلام السياسي، فقد بدأ بحلم يحبو ويدور حول إعادة الخلافة، إذ اعتقدوا أن فيها السر لعودة عز المسلمين والعرب ووحدتهم، ولكن كلما امتد نشاطهم في العمل العام انتبهوا إلى استحالة ذلك، نتيجة حالة الانهيار التي تعيشها أوطانهم، من فقر وضعف، وهيمنة أجنبي، وفساد، وأصبحوا واقعيين أكثر، ولكن كانت واقعية متدرجة وعبر مراحل، بحثوا عن فرص إقامة نموذج إسلامي إقليمي يحيون فيه حكم الشريعة المهددة، ويطبّقون عليه أفكارهم في التربية والتعليم، وقد استعانوا بالمرأجع بعد أن ألّفوا المزيد من الكتب التي توفق بين الديموقراطية والإسلام. ولقد تسأل بعضهم،
هل ندمقرط الإسلام أم نؤسلم الديموقراطية؟
وبعدها اكتشفوا لاحقاً أن لا هذا ولا ذاك ممكن، بمزيد من الواقعية.
فالراحل محفوظ النحناح في الجزائر طرح نظرية «الشوراديموقراطية»، لم تعش الفكرة أبعد من تصريح أو اثنين قالهما، فدخلت السلفية على الخط، وأعادت الجميع إلى مربع الأسئلة الأولى، هل يجوز التصويت على الشريعة وهي أمر إلهي فتكون عرضة لاختيار أو رفض البشر؟ بدت حكومات العسكر مستعصية على التغيير، وأنها واقع لا مفرّ منه، يعيشون في ظلها، فخفضوا من سقف مطالبهم ! ومن ثم اقتنع جيل من الحركات الاسلامية بانه يكفي إدخال الشريعة في الدساتير، وانشغل الإخوان المسلمون في مصر بهذا الشأن مع الرئيس السادات فاستجاب لهم، فكان الجدل حول هل تكون المصدر الأساس للتشريع أم مصدراً للتشريع، ثم انتبهوا أن لا فرق بين هذا أو ذاك، فالحكم أقوى من الدستور، والرئيس وحزبه وحكومته والمقربون هم أصحاب القرار الأخير، في الحرب والسلم، والسياسة والاقتصاد، والتعليم، والمصالح والمزايا والعلاقات الخارجية، وكل شيء.
سنوات تمرّ، يتغير فيها المجتمع والأوطان تدخل الحروب لتنتهي بهزائم، والأمة تزداد ضعفاً وهشاشة بينما العالم يتطور، ويعلي من شأن الإنتاج الاخترعات والامم تقوى، وهم يرون أن الديموقراطية هي سمة الدول الناجحة حتى خارج دول أوروبا التي صنعتها، وطبقتها كوريا الجنوبية واليابان والهند، وكثير من دول الشرق والغرب، ولم يعد من المقنع القول إن الديموقراطية فكرة غربية، وهو ذلك الغرب الذي احتربنا معه لقرون لنرفض أفكاره، ومن ثم حالفناه وقبلنا التحالف معه والحماية به ضد بعضنا البعض حتى ايامنا !
فمن خلال ذلك الزمن الطويل، المملوء بالإخفاقات على مستوى الوطن، وكذلك الحركة، وألم المعتقلات، وعجز الجميع عن تحقيق التغيير الذي بدأ قبل مئة عام، كانت هناك تجربة «إسلامية» تتشكل في تركيا، بدأت من قاعدة «أعوذ بالله من الشيطان ومن السياسة» إلى الدخول المتدرج فيها، وإخفاق يتلو إخفاقاً مع إصرار وتكيف إلى قاعدة «يمكن الدولة أن تكون علمانية، ولكن قادتها غير علمانيين»، والتي صاغها رئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان لإخوان مصر، حين زارهم وهم في الحكم، ولم يأخذوا بها.
تلك الدولة العلمانية والتي يحكمها غير علماني نجحت في تركيا، وتجاوزت الإشكال الشرعي المتوارث، وأصبحت نموذجاً للإسلاميين، فأضيف نجاحها إلى تلك المتغيرات التي عاشتها الأوطان والمجتمعات المسلمة طوال القرن، فكان لا بد أن تتغير الحركة الإسلامية إذا أرادت الاستمرار، فعلت ذلك بهدوء في المغرب، وبصخب في تونس، وعجز عن ذلك آخرون مثل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، إما لعجز فيهم، وإما لأن البيئة المحيطة بهم لم تتغيّر بما فيه الكفاية.
ولكن شروط التغيّر تتطلب أن يكون في بيئة ديموقراطية موثوقة وهو ما تفتقر اليه اغلب التجارب السابقة،
بالتأكيد للزعامات دورها، فالغنوشي مفكر إسلامي متقدم فكرياً على نظرائه الاسلاميين منذ زمن، وبالتالي لا بد من الاعتراف بدوره، كما أردوغان تركيا وبن كيران المغرب الذين لهما كاريزما الزعامة الجماهيرية، وفي طبعهما الإقدام، فنجحا في قيادة حزبيهما لهذه القفزة الكبيرة.
وعلى الاخوان المسلمون في مصر ان يعترفوا بضياع الفرصة بعد ان انشغلوا بقضية الهوية، والاستئثار بالحكم، بينما كان عليهم بناؤها وتعميق جذورها أولاً قبل الإدارة والتمكين وخطط التنمية ومشروع النهضة والإصلاح الاقتصادي والتعليمي وأي شيء آخر، فالإجابة عن معضلة تداول السلطة هي نصف الطريق لنهضة الجميع وليس جماعتهم وحدها، وهو ما فعله الغنوشي، استقرت الديموقراطية في بلاده، وبات هو وحزبه «الديموقراطي الإسلامي» مستعدَين للقفز على السلطة في الانتخابات المقبلة.
وأخيراً يقول الكاتب الخاشقجي، لو حضرت المؤتمر لسألته “والمقصود هو الشيخ راشد الغنوشي”
هل نستمر بإطلاق لقب”الشيخ”على الدعوي السابق والنهضوي والسياسي اللاحق الاستاذ راشد الغنوشي “أم السيد الرئيس”؟
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
|
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |


 الرد على تعليق
الرد على تعليق